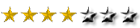الحديث عن المثلية الجنسية في سورية، وتحديداً بين الأوساط الشبابية، حديث يخالطه المزاح أكثر من الجدّ حول هذا الشاب أو ذاك. إذ أنّ الفئة العمرية الشبابية هي الأكثر حبّاً للإطلاع والاكتشاف، وموضوع من قبيل المثلية الجنسية لا يكون الحديث فيه مع الأهل… ويقوم الحديث على تشبّه الشابّ بالفتيات، نعومة الشكل، رقّة الصوت، بعض الحركات وخاصّة اللعب بالشعر، والخطأ الأسوأ الذي يمكن لشابّ ارتكابه حتى يوضع في خانة "المشبوهين" هو الاهتمام بالموضة النسائية.
إلى جانب التندر والمزاح، شاع كذلك حديث كالأسطورة عن انتشار "الحبابات- السحاقيات" في مدينة حلب، و"المثليون من الرجال" في منطقة إدلب، التي عُرفت بتندّر سكّان باقي المناطق السورية حول سمعتها هذه، حتى خرج التندّر عن إطار "المثلية" إلى "قضايا أخرى" في بعض الأحيان، إلا أنّهم، وكما يقول المثل السوريّ الأكثر انتشاراً، "لم يرَ أحدٌ شيئاً بعينيه"، وكلّ هذا كلام، وتلميحات، وتندّر… استناداً إلى ما يُشبه الاتّفاق الضمنيّ بين السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية والاجتماعية، على تعتيم الموضوع، وفق قول الرسول الكريم "وإذا بليتم بالمعاصي فاستتروا". ينطبق هذا القول على الفئات الإسلامية والمحافظة اجتماعياً بنسبة كبيرة، حيث يتماشى مع ثقافتهم الدينية التي ترفض من الأساس الاعتراف بالطبيعة المادّية للمثلية، وتعتبره خللاً أو شذوذاً غير طبيعيّ، والطبيعيّ الوحيد هو العلاقة بين رجل وامرأة، والمتنوّرون منهم يعتبرونه مرضاً بيولوجيّاً على الطبّ والعلم إيجاد العلاج المناسب له.
خارج حدود البيئة المُغلقة على ذاتها كما بعض المدن السورية ذات الطابع المحافظ، كحلب وحماة، يبقى الآخرون غير معنيّين. المتديّنون منهم إن سمعوا بحادثة ما، استعاذوا من الشيطان، وألقوا المواعظ الأخلاقية بصيغها الاستنكارية، ثمّ ينتقلون إلى حديث آخر، وكأنّ متابعة الكلام عن فعل شائن- أخلاقياً وفق معيارهم- تضفي بُعداً واقعياً على هذا الفعل. فعل لا يجب الحديث عنه، سرّي، مُحرّم، يجب ألاّ يوجد.
القسم الثاني من غير المعنيين هم العلمانيون والمثقفون ومن صاحبهم، وهؤلاء بحكم معرفتهم الفكرية وعملهم الإبداعيّ يُقرّون بواقعية المثلية الجنسية في سوريا، حتى ورد للكاتب "نبيل فياض" على أحد مواقع الانترنيت قوله: (إنّ عدد المثليين والسحاقيات يفوق توقّعاتنا. نسبتهم تصل إلى عشرين بالمئة، لكن أغلب السوريين يرفض الاعتقاد بذلك). وهؤلاء اللا معنيّون يميلون في الغالب إلى اعتبار الموضوع قضية فكرية، لا تمسّ شخصهم الكريم، إذ تبدو المثلية الجنسية- من الناحية الفكرية- أمراً فردياً بحتاً، يتّفق عليه اثنان برضاهما التامّ، دون التسبّب في أيّ إساءة كانت للآخر، ومن هنا اعتبرت حرية شخصية.
من جهتها، وبحسب موقع "عرب أون لاين" تلت الجمهورية السورية في كانون الأول/ ديسمبر 2008 في مقرّ الجمعية العامّة للأمم المتحدة بياناً مخالفاً لبيان رفع العقوبة عن المثلية الذي وقعه 66 بلداً في العالم، وقد أيّدت الدول العربية البيان السوري.
تتشابه أزمة المثلية الجنسية في سوريا مع عديد الأزمات الأخرى، التي لم يعد ممكناً النظر إليها والتعامل معها كشيء غير موجود، فالانفتاح الإلكتروني بأشكال الانترنيت والمحمول والأفلام، قدّم صوراً ملموسة للشباب السوري، هذا الذي سمح بالحديث والتندّر في مثل هذا الموضوع بين بعض الفئات، وتحديداً الشبابية منها، دون أن يُعتبر خرقاً للأعراف والتقاليد. إلا أنّ حديث المزاح والتندّر يُشكّل بذاته التفافة حول الموضوع دون مواجهته، إذ تبقى أشكال المواجهة ظرفية في غالب الأحيان، خاصة حين يسافر الشابّ أو الشابّة السوريان إلى الخارج، حيث يعيش المثليون حياتهم الطبيعية، وتكون ردود الفعل على مشاهدة اثنين من نفس الجنس في وضع عاطفيّ أو جسديّ متغايرة من شخص إلى آخر. إذ لا تزال الغالبية السورية ميّالة إلى عدم الحديث في قضية "المثلية الجنسية" رغم اعتراف البعض بها، مؤخّراً. حتى أنّ غالبية من شاهد فيلم "عمارة يعقوبيان" خرج متقزّزاً من الحالة الأخلاقية والاجتماعية المتردّية التي وصلت إليها مصر. بالنسبة للكثيرين لم يطرح الفيلم أيّة قضايا اجتماعية أو دينية خطيرة وهامّة سوى مشهد استغلال الرجل الغنيّ- ابن المدينة- المثليّ للشابّ الريفيّ الفقير، وقد حصل عليه عبر تحفيزه من خلال الخمر ومشاهدة أفلام الفحش، ممّا زاد ارتباط صورة المثلية بالمحرّمات الدينية، التي تكتسي صفة المحرّمات الأخلاقية في الواقع الاجتماعيّ. أمّا إن تجرّأ أحدهم وكتب مقالاً قارب فيه هذا الموضوع، فالبعض يقرأه بدافع الفضول، والبعض يستنكر حتى قراءته.
من هذا المنطلق شكّلت رواية "رائحة القرفة " للكاتبة السورية "سمر يزبك" صدمةً للقراء وناشطي الوسط الثقافي، باعتبارها كاتبة سورية، تحكي عن شخصيات سورية، عن سيّدة دمشقية ترتبط مع خادمتها بعلاقة مثليّة، شخصيات تنتمي إلى البيئة المحافظة اجتماعياً والمُغلقة على ذاتها. صدمة نتجت من ذكر الكاتبة لبعض تفاصيل هذه العلاقة في جانبيها الجسديّ والعاطفيّ، مما أضفى على المُتخيّل بُعداً شديد الواقعية. فما كان نصيب "رائحة القرفة" أفضل من "عمارة يعقوبيان"، إذ حاولت الكاتبة التأكيد على اهتمامها بالجانب السرديّ وأدواته في عملها هذا، لكنّ الشاغل الرئيسيّ للمتلقّين كان العلاقة المثلية، حتى وصل الأمر بالبعض إلى اتّهامها بالكتابة عن هذه القضية فقط لتحفيز الإعلام وإثارة القليل من الشغب بهدف لفت الأنظار!! قليلون من تحدّثوا عن القضايا الأدبية في الرواية، عن أزمات السّرد أو اللغة أو الإيجابيات، وبقي الحديث في صدمة العلاقة المثلية.
نبعت الأزمة من هذا التوحيد بين الفكرة القائمة في سياق وبين مُجمل العمل الأدبيّ، بحيث وجد القراء والمثقّفون أنفسهم مضطرّين إلى إطلاق حكم قيمة على ما قرؤوه، ينبع كالعادة من خانات الذائقة الأوّلية، فإمّا نحب العمل أو نكرهه، لا أن يُعجبنا لهذه الأسباب مع تحفّظات مثل… هذا كلام نقديّ لا تحبّذه ثقافتنا السورية في العموم. فكانت النتيجة الوحيدة هي كره العمل الأدبي بأكمله، انطلاقاً من الموقف المُسبق من المثلية الجنسية باعتبارها قضية ترتبط بالغريب، اللا مألوف، باعتبارها قضيّة جسدية أوّلاً وأخيراً.
تكمن الخطورة التي مثلتها "رائحة القرفة" في تقريبها "المثلية الجنسية"، وكأنّها تبعث الحياة في فكرة مُبهمة عبر شخصياتها، شيء من طراز أن يقول مثقّف ما، أو شخص متنوّر "أنا لا مشكلة لديّ مع المثليين. لهم حياتهم ولي حياتي"، وفجأة يقرع جاره المثليّ الباب داعياً إياه لشرب فنجان قهوة! هنا يكمن الالتباس الأكثر خطورة في التعاطي مع قضية "المثلية الجنسية"، من حيث كونها حرية فردية لا تسيء إلى الآخر، ولكنها في ذات الوقت- وبالنسبة لأكثر الفئات الاجتماعية- شكل وجود ينفي أبسط المسلّمات وأكثرها أوليّة، القائلة بأنّ "الرجل رجل… والمرأة مرأة..". الالتباس يكمن في ضرورة إعادة النظر في تعريفاتنا الأوليّة لمعنى الرجولة وشكلها، ومعنى الأنوثة وشكلها، خارج حدود الوظيفة الجنسية. فإن نجحنا في الاعتراف والإيمان الفعليّ بإنسانية الآخر كأهمّ صفات الوجود البشريّ، ربّما ننجح في تجاوز خوفنا ممّا تصوّرهُ لنا "المثلية الجنسية"، وربما ننجح في احترام الآخر أيّاً كانت أهواؤه الجنسية، احترامه لذاته وأفكاره، لعمله وتصرّفاته. ربما ننجح أخيراً، على الأقلّ كمثقّفين وعلمانيين في تقبّل دعوة جار مثليّ أو جارة سحاقية لتناول فنجان قهوة دون الإحساس بالخوف والاشمئزاز
هذا الموضوع مناقش بعدة منتديات لأهميته و لأظهار الرأي والرأي الآخر
أنا نقلته بتصرف مع إضافة رواية رائحة القرفة لأهميتها فمن يحب الإطلاع لا يضيع وقت وليقرأ هذه الرواية
قل الحقيقة حتى لو لم تعجب الآخرين .............فهي حقيقة
إلى جانب التندر والمزاح، شاع كذلك حديث كالأسطورة عن انتشار "الحبابات- السحاقيات" في مدينة حلب، و"المثليون من الرجال" في منطقة إدلب، التي عُرفت بتندّر سكّان باقي المناطق السورية حول سمعتها هذه، حتى خرج التندّر عن إطار "المثلية" إلى "قضايا أخرى" في بعض الأحيان، إلا أنّهم، وكما يقول المثل السوريّ الأكثر انتشاراً، "لم يرَ أحدٌ شيئاً بعينيه"، وكلّ هذا كلام، وتلميحات، وتندّر… استناداً إلى ما يُشبه الاتّفاق الضمنيّ بين السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية والاجتماعية، على تعتيم الموضوع، وفق قول الرسول الكريم "وإذا بليتم بالمعاصي فاستتروا". ينطبق هذا القول على الفئات الإسلامية والمحافظة اجتماعياً بنسبة كبيرة، حيث يتماشى مع ثقافتهم الدينية التي ترفض من الأساس الاعتراف بالطبيعة المادّية للمثلية، وتعتبره خللاً أو شذوذاً غير طبيعيّ، والطبيعيّ الوحيد هو العلاقة بين رجل وامرأة، والمتنوّرون منهم يعتبرونه مرضاً بيولوجيّاً على الطبّ والعلم إيجاد العلاج المناسب له.
خارج حدود البيئة المُغلقة على ذاتها كما بعض المدن السورية ذات الطابع المحافظ، كحلب وحماة، يبقى الآخرون غير معنيّين. المتديّنون منهم إن سمعوا بحادثة ما، استعاذوا من الشيطان، وألقوا المواعظ الأخلاقية بصيغها الاستنكارية، ثمّ ينتقلون إلى حديث آخر، وكأنّ متابعة الكلام عن فعل شائن- أخلاقياً وفق معيارهم- تضفي بُعداً واقعياً على هذا الفعل. فعل لا يجب الحديث عنه، سرّي، مُحرّم، يجب ألاّ يوجد.
القسم الثاني من غير المعنيين هم العلمانيون والمثقفون ومن صاحبهم، وهؤلاء بحكم معرفتهم الفكرية وعملهم الإبداعيّ يُقرّون بواقعية المثلية الجنسية في سوريا، حتى ورد للكاتب "نبيل فياض" على أحد مواقع الانترنيت قوله: (إنّ عدد المثليين والسحاقيات يفوق توقّعاتنا. نسبتهم تصل إلى عشرين بالمئة، لكن أغلب السوريين يرفض الاعتقاد بذلك). وهؤلاء اللا معنيّون يميلون في الغالب إلى اعتبار الموضوع قضية فكرية، لا تمسّ شخصهم الكريم، إذ تبدو المثلية الجنسية- من الناحية الفكرية- أمراً فردياً بحتاً، يتّفق عليه اثنان برضاهما التامّ، دون التسبّب في أيّ إساءة كانت للآخر، ومن هنا اعتبرت حرية شخصية.
من جهتها، وبحسب موقع "عرب أون لاين" تلت الجمهورية السورية في كانون الأول/ ديسمبر 2008 في مقرّ الجمعية العامّة للأمم المتحدة بياناً مخالفاً لبيان رفع العقوبة عن المثلية الذي وقعه 66 بلداً في العالم، وقد أيّدت الدول العربية البيان السوري.
تتشابه أزمة المثلية الجنسية في سوريا مع عديد الأزمات الأخرى، التي لم يعد ممكناً النظر إليها والتعامل معها كشيء غير موجود، فالانفتاح الإلكتروني بأشكال الانترنيت والمحمول والأفلام، قدّم صوراً ملموسة للشباب السوري، هذا الذي سمح بالحديث والتندّر في مثل هذا الموضوع بين بعض الفئات، وتحديداً الشبابية منها، دون أن يُعتبر خرقاً للأعراف والتقاليد. إلا أنّ حديث المزاح والتندّر يُشكّل بذاته التفافة حول الموضوع دون مواجهته، إذ تبقى أشكال المواجهة ظرفية في غالب الأحيان، خاصة حين يسافر الشابّ أو الشابّة السوريان إلى الخارج، حيث يعيش المثليون حياتهم الطبيعية، وتكون ردود الفعل على مشاهدة اثنين من نفس الجنس في وضع عاطفيّ أو جسديّ متغايرة من شخص إلى آخر. إذ لا تزال الغالبية السورية ميّالة إلى عدم الحديث في قضية "المثلية الجنسية" رغم اعتراف البعض بها، مؤخّراً. حتى أنّ غالبية من شاهد فيلم "عمارة يعقوبيان" خرج متقزّزاً من الحالة الأخلاقية والاجتماعية المتردّية التي وصلت إليها مصر. بالنسبة للكثيرين لم يطرح الفيلم أيّة قضايا اجتماعية أو دينية خطيرة وهامّة سوى مشهد استغلال الرجل الغنيّ- ابن المدينة- المثليّ للشابّ الريفيّ الفقير، وقد حصل عليه عبر تحفيزه من خلال الخمر ومشاهدة أفلام الفحش، ممّا زاد ارتباط صورة المثلية بالمحرّمات الدينية، التي تكتسي صفة المحرّمات الأخلاقية في الواقع الاجتماعيّ. أمّا إن تجرّأ أحدهم وكتب مقالاً قارب فيه هذا الموضوع، فالبعض يقرأه بدافع الفضول، والبعض يستنكر حتى قراءته.
من هذا المنطلق شكّلت رواية "رائحة القرفة " للكاتبة السورية "سمر يزبك" صدمةً للقراء وناشطي الوسط الثقافي، باعتبارها كاتبة سورية، تحكي عن شخصيات سورية، عن سيّدة دمشقية ترتبط مع خادمتها بعلاقة مثليّة، شخصيات تنتمي إلى البيئة المحافظة اجتماعياً والمُغلقة على ذاتها. صدمة نتجت من ذكر الكاتبة لبعض تفاصيل هذه العلاقة في جانبيها الجسديّ والعاطفيّ، مما أضفى على المُتخيّل بُعداً شديد الواقعية. فما كان نصيب "رائحة القرفة" أفضل من "عمارة يعقوبيان"، إذ حاولت الكاتبة التأكيد على اهتمامها بالجانب السرديّ وأدواته في عملها هذا، لكنّ الشاغل الرئيسيّ للمتلقّين كان العلاقة المثلية، حتى وصل الأمر بالبعض إلى اتّهامها بالكتابة عن هذه القضية فقط لتحفيز الإعلام وإثارة القليل من الشغب بهدف لفت الأنظار!! قليلون من تحدّثوا عن القضايا الأدبية في الرواية، عن أزمات السّرد أو اللغة أو الإيجابيات، وبقي الحديث في صدمة العلاقة المثلية.
نبعت الأزمة من هذا التوحيد بين الفكرة القائمة في سياق وبين مُجمل العمل الأدبيّ، بحيث وجد القراء والمثقّفون أنفسهم مضطرّين إلى إطلاق حكم قيمة على ما قرؤوه، ينبع كالعادة من خانات الذائقة الأوّلية، فإمّا نحب العمل أو نكرهه، لا أن يُعجبنا لهذه الأسباب مع تحفّظات مثل… هذا كلام نقديّ لا تحبّذه ثقافتنا السورية في العموم. فكانت النتيجة الوحيدة هي كره العمل الأدبي بأكمله، انطلاقاً من الموقف المُسبق من المثلية الجنسية باعتبارها قضية ترتبط بالغريب، اللا مألوف، باعتبارها قضيّة جسدية أوّلاً وأخيراً.
تكمن الخطورة التي مثلتها "رائحة القرفة" في تقريبها "المثلية الجنسية"، وكأنّها تبعث الحياة في فكرة مُبهمة عبر شخصياتها، شيء من طراز أن يقول مثقّف ما، أو شخص متنوّر "أنا لا مشكلة لديّ مع المثليين. لهم حياتهم ولي حياتي"، وفجأة يقرع جاره المثليّ الباب داعياً إياه لشرب فنجان قهوة! هنا يكمن الالتباس الأكثر خطورة في التعاطي مع قضية "المثلية الجنسية"، من حيث كونها حرية فردية لا تسيء إلى الآخر، ولكنها في ذات الوقت- وبالنسبة لأكثر الفئات الاجتماعية- شكل وجود ينفي أبسط المسلّمات وأكثرها أوليّة، القائلة بأنّ "الرجل رجل… والمرأة مرأة..". الالتباس يكمن في ضرورة إعادة النظر في تعريفاتنا الأوليّة لمعنى الرجولة وشكلها، ومعنى الأنوثة وشكلها، خارج حدود الوظيفة الجنسية. فإن نجحنا في الاعتراف والإيمان الفعليّ بإنسانية الآخر كأهمّ صفات الوجود البشريّ، ربّما ننجح في تجاوز خوفنا ممّا تصوّرهُ لنا "المثلية الجنسية"، وربما ننجح في احترام الآخر أيّاً كانت أهواؤه الجنسية، احترامه لذاته وأفكاره، لعمله وتصرّفاته. ربما ننجح أخيراً، على الأقلّ كمثقّفين وعلمانيين في تقبّل دعوة جار مثليّ أو جارة سحاقية لتناول فنجان قهوة دون الإحساس بالخوف والاشمئزاز
هذا الموضوع مناقش بعدة منتديات لأهميته و لأظهار الرأي والرأي الآخر
أنا نقلته بتصرف مع إضافة رواية رائحة القرفة لأهميتها فمن يحب الإطلاع لا يضيع وقت وليقرأ هذه الرواية
قل الحقيقة حتى لو لم تعجب الآخرين .............فهي حقيقة