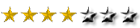عناوين كبرى.. كثير من الحبر الأسود. كثير من الدم. وقليل من الحياء .
هناك جرائد تبيعك نفس صور الصفحة الأولى.. ببدلة جديدة كل مره .
هنالك جرائد.. تبيعك نفس الأكاذيب بطريقة أقل ذكاء كل مرّة ....
وهنالك أخرى، تبيعك تذكرة للهروب من الوطن.. لا غير .
وما دام ذلك لم يعد ممكنا, فلأغلق الجريدة إذن.. ولأذهب لغسل يدي .
آخر مره استوقفتني فيها صحيفة جزائرية, كان ذلك منذ شهرين تقريبا. عندما كنت أتصفح عن طريق المصادفة, وإذا بصورتك تفاجئني على نصف صفحه بأكملها, مرفقه بحوار صحافي بمناسبة صدور كتاب جديد لك .
يومها تسمَََََّر نظري أمام ذلك الإطار الذي كان يحتويك. وعبثا رحت أفكّ رموز كلامك . كنت أقرأك مرتبكاً، متلعثماً, على عجل. وكأنني أنا الذي كنت أتحدث إليك عني, ولست أنت التي كنت تتحدثين للآخرين, عن قصة ربما لم تكن قصتنا .
أي موعد عجيب كان موعدنا ذلك اليوم! كيف لم أتوقع بعد تلك السنوات أن تحجزي لي موعدا على ورق بين صفحتين, في مجلة لا اقرأها عادة .
إنّه قانون الحماقات، أليس كذلك؟ أن أشتري مصادفة مجلة لم أتعوّد شراءها، فقط لأقلب حياتي رأساً على عقبّ
وأين العجب؟
ألم تكوني امرأة من ورق. تحب وتكره على ورق. وتهجر وتعود على ورق. وتقتل وتحيي بجرّة قلم.
فكيف لا أرتبك وأنا أقرأك. وكيف لا تعود تلك الرعشة المكهربة لتسري في جسدي، وتزيد من خفقان قلبي، وكأنني كنت أمامك، ولست أمام صورة لك.
تساءلت كثيراً بعدها، وأنا أعود بين الحين والآخر لتلك الصورة، كيف عدتِ هكذا لتتربصي بي، أنا الذي تحاشيت كل الطرق المؤدية إليك؟
كيف عدت.. بعدما كاد الجرح أن يلتئم. وكاد القلب المؤثث بذكراك أن يفرغ منك شيئاً فشيئاً وأنت تجمعين حقائب الحبّ، وتمضين فجأة لتسكني قلباً آخر.
غادرت قلبي إذن..
كما يغادر سائح مدينة جاءها في زيارة سياحية منظمة. كلّ شيء موقوت فيها مسبقاً، حتى ساعة الرحيل، ومحجوز فيها مسبقاً، حتى المعالم السياحية التي سيزورها، واسم المسرحية التي سيشاهدها، وعنوان المحلات التي سيشتري منها هدايا للذكرى.
فهل كانت رحلتك مضجرة إلى هذا الحد؟
ها أنا أمام نسخة منك، مدهوش مرتبك، وكأنني أمامك.
تفاجئني تسريحتك الجديدة. شعرك القصير الذي كان شالاً يلف وحشة ليلي.. ماذا تراك فعلت به؟
أتوقف طويلاً عند عينيك. أبحث فيهما عن ذكرى هزيمتي الأولى أمامك.
ذات يوم.. لم يكن أجمل من عينيك سوى عينيك. فما أشقاني وما أسعدني بهما!
هل تغيرت عيناك أيضاً.. أم أن نظرتي هي التي تغيرت؟ أواصل البحث في وجهك عن بصمات جنوني السابق. أكاد لا أعرف شفاهك ولا ابتسامتك وحمرتك الجديدة.
كيف حدث يوماً.. أن وجدت فيك شبهاً بأمي. كيف تصورتك تلبسين ثوبها العنابي، وتعجنين بهذه الأيدي ذات الأظافر المطلية الطويلة، تلك الكسرة التي افتقدت مذاقها منذ سنين؟
أيّ جنون كان لك.. وأية حماقة!
هل غيّر الزواج حقاً ملامحك وضحكتك الطفولية، هل غيّر ذاكرتك أيضاً، ومذاق شفاهك وسمرتك الغجرية؟
وهل أنساك ذلك "النبي المفلس" الذي سرقوا منه الوصايا العشر وهو في طريقه إليك.. فجاءك بالوصية الحادية عشرة فقط.
ها أنت ذي أمامي، تلبسين ثوب الردّة. لقد اخترت طريقاً آخر. ولبست وجهاً آخر لم أعد أعرفه. وجهاً كذلك الذي نصادفه في المجلات والإعلانات، لتلك النساء الواجهة، المعدات مسبقاً لبيع شيء ما، قد يكون معجون أسنان، أو مرهماً ضد التجاعيد.
أم تراك لبست هذا القناع، فقط لتروّجي لبضاعة في شكل كتاب، أسميتها "منعطف النسيان" بضاعة قد تكون قصتي معك.. وذاكرة جرحي؟
وقد تكون آخر طريقه وجدتها لقتلي اليوم من جديد, دون أن تتركي بصماتك على عنقي .
يومها تذكرت حديثاً قديماً لنا . عندما سألتك مرة لماذا اخترتِ الرواية بالذات. وإذا بجوابك يدهشني .
قلت يومها بابتسامة لم أدرك نسبة الصدق فيها من نسبة التحايل:
" كان لا بد أن أضع شيئا من الترتيب داخلي.. وأتخلص من بعض الأثاث القديم . إنَّ أعماقنا أيضا في حاجة إلى نفض كأيّ بيت نسكنه ولا يمكن أن أبقي نوافذي مغلقه هكذا على أكثر من جثة ..
إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غير, وننتهي من الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبئاً على حياتنا. فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم... وامتلأنا بهواء نظيف ..." .
وأضفت بعد شيء من الصمت:
" في الحقيقة كل رواية ناجحة, هي جريمة ما نرتكبها تجاه ذاكرة ما. وربما تجاه شخص ما, على مرأى من الجميع بكاتم صوت. ووحده يدري أنَّ تلك الكلمة الرصاصة كانت موجّهة إليه
...
والروايات الفاشلة, ليست سوى جرائم فاشلة, لا بد أن تسحب من أصحابها رخصة حمل القلم, بحجة أنهم لا يحسنون استعمال الكلمات, وقد يقتلون خطأ بها أيّ احد .. بمن في ذلك أنفسهم , بعدما يكونون قد قتلوا القراء ... ضجراً !".
كيف لم تثر نزعتك الساديّة شكوكي يومها .. وكيف لم أتوقع كل جرائمك التي تلت ذلك اليوم, والتي جربت فيها أسلحتك الأخرى؟
لم أكن أتوقع يومها انك قد توجهين يوما رصاصك نحوي .
ولذا ضحكت لكلامك, وربما بدأ يومها انبهاري الآخر بك. فنحن لا نقاوم, في هذه الحالات , جنون الإعجاب بقاتلنا !
ورغم ذلك أبديت لك دهشتي . قلت :
_ كنت اعتقد أن الرواية طريقه الكاتب في أن يعيش مرة ثانيه قصه أحبها.. وطريقته في منح الخلود لمن أحب .
وكأنّ كلامي فاجأك فقلت وكأنك تكتشفين شيئا لم تحسبي له حسابا:
- وربما كان صحيحا أيضا, فنحن في النهاية لا نقتل سوى من أحببنا. ونمنحهم تعويضا عن ذلك خلودا أدبيا . إنها صفقه عادلة . أليس كذلك؟!
عادله ؟
من يناقش الطغاة في عدلهم أو ظلمهم؟ ومن يناقش نيرون يوم احرق روما حباً لها, وعشقاً لشهوة اللهب . وأنت, أما كنت مثله امرأة تحترف العشق والحرائق بالتساوي؟
أكنت لحظتها تتنبّأين بنهايتي القريبة، وتواسينني مسبقا على فجيعتي...
أم كنت تتلاعبين بالكلمات كعادتك, و وتتفرجين على وقعها عليّ, وتسعدين سرّاً باندهاشي الدائم أمامك, وانبهاري بقدرتك المذهلة, في خلق لغة على قياس تناقضك .
كل الاحتمالات كانت ممكنه ...
فربما كنت أنا ضحية روايتك هذه, والجثة التي حكمت عليها بالخلود, وقررت أن تحنطيها بالكلمات... كالعادة.
و ربما كنت ضحية وهمي فقط, ومراوغتك التي تشبه الصدق. فوحدك تعرفين في النهاية الجواب على كل تلك الأسئلة التي ظلت تطاردني, بعناد الذي يبحث عن الحقيقة دون جدوى .
متى كتبتِ ذلك الكتاب؟
أقبل زواجك أم بعده؟ أقبل رحيل زياد .. أم بعده؟ أكتبته عني .. أم كتبته عنه؟ أكتبته لتقتليني به.. أم لتحييه هو ؟
لم لتنتهي منّا معاً، وتقتلينا معاً بكتاب واحد... كما تركتنا معاً من أجل رجل واحد ؟
عندما قرأت ذلك الخبر منذ شهرين,. لم أتوقع إطلاقاًً أن تعودي فجأة بذلك الحضور الملحِّ, ليصبح كتابك محور تفكيري, ودائرة مغلقه أدور فيها وحدي .
فلا كان ممكنا يومها بعد كل الذي حدث, أن اذهب للبحث عنه في المكتبات , لأشتري قصتي من بائع مقابل ورقه نقدية. ولا كان ممكنا أيضا أن أتجاهله وأواصل حياتي وكأنني لم اسمع به , وكأن أمره لا يعنيني تماما .
الم أكن متحرقا إلى قراءة بقية القصة؟
قصتك التي انتهت في غفلة مني , دون أن أعرف فصولها الأخيرة. تلك التي كنت شاهدها الغائب, بعدما كنت شاهدها الأول. أنا الذي كنت,. حسب قانون الحماقات نفسه. الشاهد والشهيد دائما في قصة لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحد .
ها هوذا كتابك أمامي.. لم يعد بإمكاني اليوم أن أقرأه. فتركته هنا على طاولتي مغلقا كلغز, يتربص بي كقنبلة موقوتة, أستعين بحضوره الصامت لتفجير منجم الكلمات داخلي ... واستفزاز الذاكرة .
كل شيء فيه يستفزني اليوم .. عنوانه الذي اخترته بمراوغه واضحة.. وابتسامتك التي تتجاهل حزني . ونظرتك المحايدة التي تعاملني وكأنني قارىء, لا يعرف الكثير عنك .
كل شيء.. حتى اسمك .
وربما كان اسمك الأكثر استفزازا لي, فهو مازال يقفز إلى الذاكرة قبل أن تقفز حروفه المميزة إلى العين .
اسمك الذي .. لا يُقرأ وإنما يُسمع كموسيقى تُعزف على آلة واحدة من أجل مستمع واحد.
كيف لي أن أقرأه بحياد, وهو فصل من قصة مدهشه كتبتها الصدفة, وكتبها قدرنا الذي تقاطع يوما؟
يقول تعليق على ظهر كتابك إنه حدث أدبي .
وأقول وأنا أضع عليه حزمة من الأوراق التي سودتها في لحظة هذيان..
" حان لك أن تكتب.. أو تصمت إلى الأبد أيها الرجل . فما أعجب ما يحدث هذه الأيام !"
وفجأة.. يحسم البرد الموقف, ويزحف ليل قسنطينة نحوي من نافذة للوحشة. فأعيد للقلم غطاءه, وانزلق بدوري تحت غطاء الوحدة .
مذ أدركت أن لكل مدينةٍ الليل الذي تستحق, الليل الذي يشبهها والذي وحده يفضحها, ويعري في العتمة ما تخفيه في النهار, قررت أن أتحاشى النظر ليلا من هذه النافذة .
كل المدن تمارس التعري ليلا دون علمها, وتفضح للغرباء أسرارها , حتى عندما لا تقول شيئا .
وحتى عندما توصد أبوابها.
ولأن المدن كالنساء, يحدث لبعضهن أن يجعلننا نستعجل قدوم الصباح. ولكن ...
"soirs, soirs.que de soirs pour un seul matin .."
كيف تذكرت هذا البيت للشاعر "هنري ميشو" ورحت اردده على نفسي بأكثر من لغة ..
"أمسيات .. أمسيات كم من مساء لصباح واحد "
هناك جرائد تبيعك نفس صور الصفحة الأولى.. ببدلة جديدة كل مره .
هنالك جرائد.. تبيعك نفس الأكاذيب بطريقة أقل ذكاء كل مرّة ....
وهنالك أخرى، تبيعك تذكرة للهروب من الوطن.. لا غير .
وما دام ذلك لم يعد ممكنا, فلأغلق الجريدة إذن.. ولأذهب لغسل يدي .
آخر مره استوقفتني فيها صحيفة جزائرية, كان ذلك منذ شهرين تقريبا. عندما كنت أتصفح عن طريق المصادفة, وإذا بصورتك تفاجئني على نصف صفحه بأكملها, مرفقه بحوار صحافي بمناسبة صدور كتاب جديد لك .
يومها تسمَََََّر نظري أمام ذلك الإطار الذي كان يحتويك. وعبثا رحت أفكّ رموز كلامك . كنت أقرأك مرتبكاً، متلعثماً, على عجل. وكأنني أنا الذي كنت أتحدث إليك عني, ولست أنت التي كنت تتحدثين للآخرين, عن قصة ربما لم تكن قصتنا .
أي موعد عجيب كان موعدنا ذلك اليوم! كيف لم أتوقع بعد تلك السنوات أن تحجزي لي موعدا على ورق بين صفحتين, في مجلة لا اقرأها عادة .
إنّه قانون الحماقات، أليس كذلك؟ أن أشتري مصادفة مجلة لم أتعوّد شراءها، فقط لأقلب حياتي رأساً على عقبّ
وأين العجب؟
ألم تكوني امرأة من ورق. تحب وتكره على ورق. وتهجر وتعود على ورق. وتقتل وتحيي بجرّة قلم.
فكيف لا أرتبك وأنا أقرأك. وكيف لا تعود تلك الرعشة المكهربة لتسري في جسدي، وتزيد من خفقان قلبي، وكأنني كنت أمامك، ولست أمام صورة لك.
تساءلت كثيراً بعدها، وأنا أعود بين الحين والآخر لتلك الصورة، كيف عدتِ هكذا لتتربصي بي، أنا الذي تحاشيت كل الطرق المؤدية إليك؟
كيف عدت.. بعدما كاد الجرح أن يلتئم. وكاد القلب المؤثث بذكراك أن يفرغ منك شيئاً فشيئاً وأنت تجمعين حقائب الحبّ، وتمضين فجأة لتسكني قلباً آخر.
غادرت قلبي إذن..
كما يغادر سائح مدينة جاءها في زيارة سياحية منظمة. كلّ شيء موقوت فيها مسبقاً، حتى ساعة الرحيل، ومحجوز فيها مسبقاً، حتى المعالم السياحية التي سيزورها، واسم المسرحية التي سيشاهدها، وعنوان المحلات التي سيشتري منها هدايا للذكرى.
فهل كانت رحلتك مضجرة إلى هذا الحد؟
ها أنا أمام نسخة منك، مدهوش مرتبك، وكأنني أمامك.
تفاجئني تسريحتك الجديدة. شعرك القصير الذي كان شالاً يلف وحشة ليلي.. ماذا تراك فعلت به؟
أتوقف طويلاً عند عينيك. أبحث فيهما عن ذكرى هزيمتي الأولى أمامك.
ذات يوم.. لم يكن أجمل من عينيك سوى عينيك. فما أشقاني وما أسعدني بهما!
هل تغيرت عيناك أيضاً.. أم أن نظرتي هي التي تغيرت؟ أواصل البحث في وجهك عن بصمات جنوني السابق. أكاد لا أعرف شفاهك ولا ابتسامتك وحمرتك الجديدة.
كيف حدث يوماً.. أن وجدت فيك شبهاً بأمي. كيف تصورتك تلبسين ثوبها العنابي، وتعجنين بهذه الأيدي ذات الأظافر المطلية الطويلة، تلك الكسرة التي افتقدت مذاقها منذ سنين؟
أيّ جنون كان لك.. وأية حماقة!
هل غيّر الزواج حقاً ملامحك وضحكتك الطفولية، هل غيّر ذاكرتك أيضاً، ومذاق شفاهك وسمرتك الغجرية؟
وهل أنساك ذلك "النبي المفلس" الذي سرقوا منه الوصايا العشر وهو في طريقه إليك.. فجاءك بالوصية الحادية عشرة فقط.
ها أنت ذي أمامي، تلبسين ثوب الردّة. لقد اخترت طريقاً آخر. ولبست وجهاً آخر لم أعد أعرفه. وجهاً كذلك الذي نصادفه في المجلات والإعلانات، لتلك النساء الواجهة، المعدات مسبقاً لبيع شيء ما، قد يكون معجون أسنان، أو مرهماً ضد التجاعيد.
أم تراك لبست هذا القناع، فقط لتروّجي لبضاعة في شكل كتاب، أسميتها "منعطف النسيان" بضاعة قد تكون قصتي معك.. وذاكرة جرحي؟
وقد تكون آخر طريقه وجدتها لقتلي اليوم من جديد, دون أن تتركي بصماتك على عنقي .
يومها تذكرت حديثاً قديماً لنا . عندما سألتك مرة لماذا اخترتِ الرواية بالذات. وإذا بجوابك يدهشني .
قلت يومها بابتسامة لم أدرك نسبة الصدق فيها من نسبة التحايل:
" كان لا بد أن أضع شيئا من الترتيب داخلي.. وأتخلص من بعض الأثاث القديم . إنَّ أعماقنا أيضا في حاجة إلى نفض كأيّ بيت نسكنه ولا يمكن أن أبقي نوافذي مغلقه هكذا على أكثر من جثة ..
إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غير, وننتهي من الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبئاً على حياتنا. فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم... وامتلأنا بهواء نظيف ..." .
وأضفت بعد شيء من الصمت:
" في الحقيقة كل رواية ناجحة, هي جريمة ما نرتكبها تجاه ذاكرة ما. وربما تجاه شخص ما, على مرأى من الجميع بكاتم صوت. ووحده يدري أنَّ تلك الكلمة الرصاصة كانت موجّهة إليه
...
والروايات الفاشلة, ليست سوى جرائم فاشلة, لا بد أن تسحب من أصحابها رخصة حمل القلم, بحجة أنهم لا يحسنون استعمال الكلمات, وقد يقتلون خطأ بها أيّ احد .. بمن في ذلك أنفسهم , بعدما يكونون قد قتلوا القراء ... ضجراً !".
كيف لم تثر نزعتك الساديّة شكوكي يومها .. وكيف لم أتوقع كل جرائمك التي تلت ذلك اليوم, والتي جربت فيها أسلحتك الأخرى؟
لم أكن أتوقع يومها انك قد توجهين يوما رصاصك نحوي .
ولذا ضحكت لكلامك, وربما بدأ يومها انبهاري الآخر بك. فنحن لا نقاوم, في هذه الحالات , جنون الإعجاب بقاتلنا !
ورغم ذلك أبديت لك دهشتي . قلت :
_ كنت اعتقد أن الرواية طريقه الكاتب في أن يعيش مرة ثانيه قصه أحبها.. وطريقته في منح الخلود لمن أحب .
وكأنّ كلامي فاجأك فقلت وكأنك تكتشفين شيئا لم تحسبي له حسابا:
- وربما كان صحيحا أيضا, فنحن في النهاية لا نقتل سوى من أحببنا. ونمنحهم تعويضا عن ذلك خلودا أدبيا . إنها صفقه عادلة . أليس كذلك؟!
عادله ؟
من يناقش الطغاة في عدلهم أو ظلمهم؟ ومن يناقش نيرون يوم احرق روما حباً لها, وعشقاً لشهوة اللهب . وأنت, أما كنت مثله امرأة تحترف العشق والحرائق بالتساوي؟
أكنت لحظتها تتنبّأين بنهايتي القريبة، وتواسينني مسبقا على فجيعتي...
أم كنت تتلاعبين بالكلمات كعادتك, و وتتفرجين على وقعها عليّ, وتسعدين سرّاً باندهاشي الدائم أمامك, وانبهاري بقدرتك المذهلة, في خلق لغة على قياس تناقضك .
كل الاحتمالات كانت ممكنه ...
فربما كنت أنا ضحية روايتك هذه, والجثة التي حكمت عليها بالخلود, وقررت أن تحنطيها بالكلمات... كالعادة.
و ربما كنت ضحية وهمي فقط, ومراوغتك التي تشبه الصدق. فوحدك تعرفين في النهاية الجواب على كل تلك الأسئلة التي ظلت تطاردني, بعناد الذي يبحث عن الحقيقة دون جدوى .
متى كتبتِ ذلك الكتاب؟
أقبل زواجك أم بعده؟ أقبل رحيل زياد .. أم بعده؟ أكتبته عني .. أم كتبته عنه؟ أكتبته لتقتليني به.. أم لتحييه هو ؟
لم لتنتهي منّا معاً، وتقتلينا معاً بكتاب واحد... كما تركتنا معاً من أجل رجل واحد ؟
عندما قرأت ذلك الخبر منذ شهرين,. لم أتوقع إطلاقاًً أن تعودي فجأة بذلك الحضور الملحِّ, ليصبح كتابك محور تفكيري, ودائرة مغلقه أدور فيها وحدي .
فلا كان ممكنا يومها بعد كل الذي حدث, أن اذهب للبحث عنه في المكتبات , لأشتري قصتي من بائع مقابل ورقه نقدية. ولا كان ممكنا أيضا أن أتجاهله وأواصل حياتي وكأنني لم اسمع به , وكأن أمره لا يعنيني تماما .
الم أكن متحرقا إلى قراءة بقية القصة؟
قصتك التي انتهت في غفلة مني , دون أن أعرف فصولها الأخيرة. تلك التي كنت شاهدها الغائب, بعدما كنت شاهدها الأول. أنا الذي كنت,. حسب قانون الحماقات نفسه. الشاهد والشهيد دائما في قصة لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحد .
ها هوذا كتابك أمامي.. لم يعد بإمكاني اليوم أن أقرأه. فتركته هنا على طاولتي مغلقا كلغز, يتربص بي كقنبلة موقوتة, أستعين بحضوره الصامت لتفجير منجم الكلمات داخلي ... واستفزاز الذاكرة .
كل شيء فيه يستفزني اليوم .. عنوانه الذي اخترته بمراوغه واضحة.. وابتسامتك التي تتجاهل حزني . ونظرتك المحايدة التي تعاملني وكأنني قارىء, لا يعرف الكثير عنك .
كل شيء.. حتى اسمك .
وربما كان اسمك الأكثر استفزازا لي, فهو مازال يقفز إلى الذاكرة قبل أن تقفز حروفه المميزة إلى العين .
اسمك الذي .. لا يُقرأ وإنما يُسمع كموسيقى تُعزف على آلة واحدة من أجل مستمع واحد.
كيف لي أن أقرأه بحياد, وهو فصل من قصة مدهشه كتبتها الصدفة, وكتبها قدرنا الذي تقاطع يوما؟
يقول تعليق على ظهر كتابك إنه حدث أدبي .
وأقول وأنا أضع عليه حزمة من الأوراق التي سودتها في لحظة هذيان..
" حان لك أن تكتب.. أو تصمت إلى الأبد أيها الرجل . فما أعجب ما يحدث هذه الأيام !"
وفجأة.. يحسم البرد الموقف, ويزحف ليل قسنطينة نحوي من نافذة للوحشة. فأعيد للقلم غطاءه, وانزلق بدوري تحت غطاء الوحدة .
مذ أدركت أن لكل مدينةٍ الليل الذي تستحق, الليل الذي يشبهها والذي وحده يفضحها, ويعري في العتمة ما تخفيه في النهار, قررت أن أتحاشى النظر ليلا من هذه النافذة .
كل المدن تمارس التعري ليلا دون علمها, وتفضح للغرباء أسرارها , حتى عندما لا تقول شيئا .
وحتى عندما توصد أبوابها.
ولأن المدن كالنساء, يحدث لبعضهن أن يجعلننا نستعجل قدوم الصباح. ولكن ...
"soirs, soirs.que de soirs pour un seul matin .."
كيف تذكرت هذا البيت للشاعر "هنري ميشو" ورحت اردده على نفسي بأكثر من لغة ..
"أمسيات .. أمسيات كم من مساء لصباح واحد "